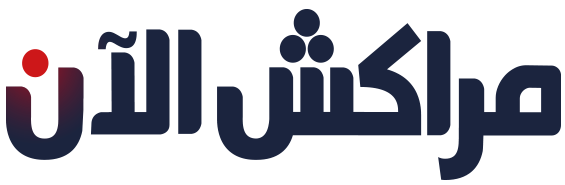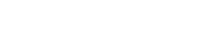مراد حنبلي يكتب: الغرف المهنية وموقعها في السياسات التنموية بالمغرب

محمد مراد حنبلي – عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي
في ظل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب خاصة تلك المرتبطة بانخراط المؤسسات والمقاولات العمومية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وموازاة لإصدار كتابة الدولة في الصناعة التقليدية استمارة قصد استطلاع أراء مختلف الفاعلين في القطاع حول ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بغية “تمكينها من القيام بوظائفها الدستورية كاملة وجعلها فاعلا أساسيا محوريا مساهما في تنمية قطاع الصناعة التقليدية وشريكا أساسيا للدولة في تنمية هذا القطاع وتطويره والارتقاء به” حسب ما ورد في ديباجة الاستمارة، سأركز في هذه المقالة في خطوط عريضة فقط على الإشكالات البنيوية وليس التقنية التي تستوجب منحها الأولوية في التعديلات المنتظرة.
المحور الأول: قيام الغرف بوظائفها الدستورية
1- التمثيلية
إن نجاح كل مؤسسة عمومية، وأخص بالذكر هنا المؤسسات العمومية المنتخبة ينطلق أساسا من مدى تمثيليتها الحقيقية لواقع القطاع الذي تمثله.
فتحديد المجال الترابي للدوائر الانتخابية، نمط الاقتراع، توزيع الأصناف، عدد المنتخبين عن كل صنف، المعايير والشروط الواجب توفرها في الناخبين وفي المرشحين ليست مجرد آليات تقنية بحتة، بل وجب اعتبارها العمود الفقري في هيكلة كل مؤسسة تبتغي توفير الأرضية الصلبة والشروط الموضوعية لوضع مخططات وسياسات تنموية.
ومما يزيد الطين بلة، ونحن نتفق أن الوظيفة الأساسية للغرف هي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، هو إقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية، والتي تفاقمت في الولايتين الأخيرتين بشكل فظيع.
وللمتتبع لشؤون الغرف أمثلة عديدة وصلت إلى حالة شلل في بعضها والتركيز على خلافات هامشية أفقدت جل الغرف بوصلتها، لذا وجب فرض الترشيح للغرف بدون انتماء سياسي.
وحتى تشكل قوة فاعلة ومؤثرة داخل مجلس المستشارين، فيمكن جمع مستشاري الغرف في فريق برلماني كما هو الحال بالنسبة للكونفدرالية العامة لأرباب العمل.
إشكال آخر يخص التمثيلية، هذه المرة تمثيلية القطاع داخل المؤسسات المنتخبة الأخرى، حتى 2015، كانت الغرف ممثلة بمجالس العمالات والأقاليم وبمجالس الجهات، مما يجعل صوت الصانع التقليدي، ولو بشكل محدود يتواجد داخل مداولات هذه المجالس، تحققت معه تمويل وإنجاز عدة برامج ومشاريع لفائدة القطاع.
لكن بحذف تلك التمثيلية، لاحظنا بشكل جلي خلال العقد الأخير، غياب تام لأي بادرة لهذه المجالس في برامجها وميزانياتها.
فأملنا في خضم الإصلاحات القانونية والهيكلية المقبلة أن يتم التنصيص مجددا على تمثيلية الغرف في هذه المجالس.
2- اختصاصات ومهام الغرف
حين قراءتنا لمضامين القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، نذهل للحيز الكبير الذي يشغله باب اختصاصات الغرف، ويتضح جليا أن المشرع كان سخيا في “إقحام” الغرف في مجالات يعلم جيدا أن ليس لديها الإمكانات لا التنظيمية ولا المالية ولا التدبيرية لتحملها أو حتى المساهمة في إنجازها.
كما يلاحظ منحها اختصاصات دون وضع رؤية واضحة ودون التحضير اللوجستيكي والتقني والمالي من أجل تفعيلها، وبعضها ما زال ينتظر نصوصا تنظيمية، فهي اختصاصات مع وقف التنفيذ، وبالتالي ظلت حبرا على ورق.
وحتى الاختصاصات التي نرى أن الغرفة تلعب فيها أدورا نجدها هزيلة ولا ترقى إلى مستوى طموحات الصناع التقليديين، إما لغياب الوسائل الضرورية أو لسوء الحكامة والتدبير في مجالات عدة.
3- تداخل الاختصاصات
إشكالية أخرى تطرح عن تداخل أدوارها واختصاصاتها مع مؤسسات أخرى. فمثلا، نجد داخل المجال الترابي للغرفة عديدة هي المهام المنوطة بها تمارسها بالموازاة معها المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة.
تداخل آخر ولو أنه مؤجل إلى حين يتمثل في الاختصاصات والمهام التي منحها المشرع للهيئات الحرفية الجهوية والإقليمية في إطار القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، خاصة المواد 14-15-16 و19، التي تتحدث عن نفس الاختصاصات الممنوحة للغرف بالرغم من استهلال هذه المواد بعبارة فضفاضة وغير محددة وهي ” مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندةلغرف الصناعة التقليدية…”.
فرغم صدور القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2020 إلا أن هذه الهيئات الحرفية لم ترى النور بعد لعدم صدور العديد من النصوص التنظيمية.
4- الهيكلة الإدارية
من عجائب القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية هو تخصيصه لمادة واحدة لإدارة الغرفة وهي المادة 26: “يساعد رئيس غرفة الصناعة التقليدية في القيام بمهامه طاقم إداري تحت إشراف مدير …”، وهذا ما يعكس بجلاء نظرة المشرع السلبية والمسبقة لهذه المؤسسة.
فالكل يعلم أن دور الإدارة أساسي في حسن التدبير وخاصة في حسن التنفيذ لكل مخططات ومشاريع كل مؤسسة عمومية كيفما كانت طبيعتها، لذا وجب أن ينعكس ذلك داخل المنظومة القانونية للغرف.
المحور الثاني: الغرفة كفاعل أساسي ومحوري ومساهم في تنمية قطاع الصناعة التقليدية
حتى اليوم يبقى دور الغرف هامشيا وأثبت عقمه وعدم نجاعته في خدمة الصانع التقليدي في تحسين ظروف اشتغاله من جهة وفي ترويج وتسويق المنتوج التقليدي من جهة أخرى.
فالتمثيلية الحقة وإيصال أصواتهم لمختلف المؤسسات العمومية الأخرى، مازال مبتغى بعيد المنال للصناع التقليديين.
فالغرف غائبة في مواكبة الصانع التقليدي في كل الصعوبات والعراقيل التي يواجهها بدءا من مصاحبته في خلق مقاولته أو بدء مشروعه، مرورا بمشاكل المواد الأولية، التكوين المستمر، التسويق وغيرها ووصولا إلى الوساطة في ميادين التمويل والترويج.
وتبقى المساهمة اليتيمة للغرف تتمثل في التسويق باعتماد صيغة وحيدة هي تنظيم معارض محلية وجهوية دون تحقيق نتائج ملموسة على واقع الصانع التقليدي.
نفس التخبط، تعيشه الغرف (باستثناء غرفة أو غرفتين) مع برامج التكوين بالتدرج المهني التي تخصص لها سنويا على الصعيد الوطني ملايين الدراهم، لكن دون وقع إيجابي ملموس سواء على مستوى التكوين أو على مستوى ولوج سوق الشغل.
مئات الخريجين ينضافون إلى طوابير البطالة، دون الحديث عن النسبة المهولة للمنقطعين خلال مدة التكوين.
نحن في أمس الحاجة إلى وقفة للقيام بدراسات وافتحاصات لتقييم نجاعة الأداء بقياس العديد من المؤشرات ومدى تطورها.
المحور الثالث: كيف للغرف أن تكون شريكا أساسيا للدولة ولمختلف المؤسسات
ما دامت الغرف هي ممثلة الصانع التقليدي أمام المؤسسات الأخرى، فكل مناحي الحياة المرتبطة بعمله وبوضعه الاجتماعي والصحي هي جزء من اهتماماتها.
ومن خلال قراءة للاختصاصات والمهام المنوطة بالغرف في القانون الأساسي نجد مبدئيا التنصيص على إمكانية التعامل والتنسيق والشراكة مع العديد من الأطراف على مختلف الأصعدة.
مع المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية المحلية والجهوية، للأسف الشديد يبقى دور الغرف ضعيفا في مجالات الدعم والتوجيه والمواكبة.
فباستثناء بعد اللقاءات التحسيسية التي تستدعى فيها بعض المصالح الخارجية (الضمان الاجتماعي، مديرية الضرائب، مديرية الجمارك، مكتب تنمية التعاون ….) لتقديم إيضاحات والجواب عن استفسارات، نفتقد المتابعة الميدانية والمواكبة الشخصية لملفات الصناع التقليديين.
مع الجماعات الترابية، نجد الغياب الواضح للغرف، فمع المجالس الجماعية والسلطات المحلية، يتخبط الصانع التقليدي في مشاكل جمة بدءا من ترخيص الممارسة، تأطير احتلال الملك العمومي، وضعيته القانونية في المناطق المخصصة للأنشطة الحرفية التي تحولت لأحياء سكنية، مرورا بالجبايات المحلية، ووصولا إلى غياب أحياء صناعية من الدرجة الثالثة وصعوبة تنظيم تظاهرات ترويجية للمنتوج التقليدي.
أما مع مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات فسبق الحديث عنها في المحور الأول.
مع الإدارة المركزية، نرى عدم وضوح الرؤيا وتذبذب واضح في تعامل الوزارة مع الغرف، بممارسة وصاية “أبوية” أحيانا والتعامل مع الغرف كفاعل “قاصر”.
فاستشارتها في ميادين التشريع وفي وضع البرامج والمخططات تبقى شكلية. كما أن تقزيم أدوارها في تفاقم مستمر.
لذا وتماشيا مع أحكام القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وأمام الأوضاع الحالية التي تعيشها الغرف، أرى أنه من الواجب العمل عل تجميع الغرف المهنية في غرفة واحدة.
وتحدد هيكلتها وتنظيمها على شاكلة هيكلة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، فتجميع الغرف في غرفة واحدة ليست بدعة جديدة بل تعمل بها مجموعة من الدول وفي مقدمتها اسبانيا.
كما أن لنا في التجربة الفرنسية مثال في التنظيم الترابي بين المستويين الجهوي والإقليمي.
فاستلهام دروس من هذه التجارب مع مراعاة خصوصيات واقعنا المهني، سيمنحنا الوصول إلى مؤسسات ذات فاعلية، ومخاطب قوي امام السلطات المركزية والجهوية وبالتالي سيساهم في حل العديد من المشاكل البنيوية التي تتخبط فيها الغرف المهنية.
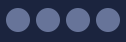 مشاهدة المزيد ←
مشاهدة المزيد ←